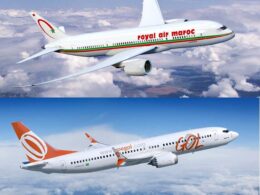عندما تزور باريس سينصحك حتما أي فرنسي بإلحاح لزيارة حديقة التأقلم أو Le Jardin d’Acclimatation التي أصبحت محطة رئيسية لكل جولة محترمة في عاصمة الأنوار.
ولهذه الحديقة حكاية عجيبة يجب أن تروى لنستشف منها دروسا لابد ستنفعنا في زمن المقاطعة هذا الذي نعيشه منذ حوال ثلاثة أشهر.
فحديقة التأقم هذه تعتبر واحدة من أقدم الحدائق الباريسية حيث أنشأت سنة 1860 من طرف نابليون الثالث، بالقرب من غابة بولونيا الشهيرة، تضم مجموعة من الألعاب الترفيهية والمتاجر والحيوانات والطيور المختلفة …
وبعد مدة إغلاق دامت 9 أشهر، فتحت الحديقة أبوابها من جديد في بداية شهر يونيو الماضي لتستقبل زوارها من جميع أنحاء العالم، حيث خضعت للتجديد وأضيفت لها الكثير من التغييرات لكن مع الحفاظ على طابعها الأصلي وروحها الضاربة في التاريخ.
الهدف ؟ هو المرور من مليوني زائر الآن، إلى 3 ملايين زائر في أفق 2025. ومن أجل الوصول إلى مبتغاها استثمرت الشركة المكلفة بالتدبير ميزانية تعدت 60 مليون أورو.
وحتى نعود إلى موضعنا الأصلي هنا في المغرب، والآن في زمن المقاطعة، لابد من التدقيق في بعض الأمور: فالشركة التي تدبر حديقة التأقلم هذه، ليست سوى LVMH التي نشأت من خلال الاندماج بين رواد في مجال الخمور وصناعة الاكسسوارات الفاخرة، والتي يعرف المغاربة منتجاتها من خلال الماركات الشهيرة، لوي فيتون، وجيفانشي، وكريستيان ديور الباهضة الثمن، حيث الى جانب اهتمامها بالموضة والفخامة باعتبارها رائدة في المجال، والشركة الأولى في العالم على رأس شركات اللباس الفاخر حسب العائدات، فإنها تستثمر أيضا في حديقة للترفيه ثمن التذكرة الكاملة للاستفادة من جميع العابها تبلغ 29 اورو، اي حوالي 300 درهم، وهو مبلغ لا يمثل الكثير للمواطن الفرنسي، مع وجود تخفيضات لفئات مختلفة بينها العائلات المتعددة أي التي لها اكثر من طفلين. بالإضافة إلى أن 30 في المائة من مليوني زائر يستفيدون من الحديقة وملاهيها مجانا بينهم تلاميذ، وذوي الاحتياجات الخاصة … أي أن شركة الفخامة الشهيرة لا تبتغي الربح المادي من المشروع، لأن حقائبها اليدوية كفيلة بذلك، بل القيام بدورها كشركة مواطنة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية أو مايسميه الفرنسيون RSE أي La responsabilité sociétale des entreprises.
واذا كانت هذه المسؤولية تفرض على الشركات الاتزام بالقوانين المختلفة خاصة ما يتعلق بحقوق العاملين، والحفاظ على البيئة.. فإنها في الآن ذاته تلزمها بالعمل على تحسين ظروف المعيشة للعاملين وعائلاتهم، وفي محيطها، وفي المجتمع ككل. وهو ما تقوم به الشركة الفرنسية المذكورة بتبنيها لحديقة عمرها حوالي قرن ونصف من الزمن باعتبارها جاذبا قويا للسياح، ومتنفسا لملايين الباريسيين.
بلغة أخرى، ما نعيشه اليوم من أزمة بين الرأسمال والمستهلك، هو فقدان الثقة في هذه الشركات التي لم تقم بدورها، بشكل مطلق أو غير كافي، تجاه محيطها والمجتمع. وهنا لا نقصد الشركات المعنية بالمقاطعة فحسب، بل جميع الشركات التي رغم تبني الاتحاد العام لمقاولات المغرب ل”ميثاق المسؤولية المجتمعية للمقاولات” بقي الأمر حبرا على ورق، حيث اتخذه البعض حافزا تسويقيا أو واجهة اشهارية للتباهي فحسب، في حين اتسم تعاملها على أرض الواقع بمنطق “اللهطة” بدل منطق العقل، وبمبدأ “أنا وبعدي الطوفان”، بدل مبدأ التنمية المستدامة. وعلى ما نعتقد فإن حملة المقاطعة فضحت كل هذا بشكل صارخ اليوم، ورمت بالكرة في ملعب الشركات التي ترى في المقاطعة « باطلا أريد به حق ».